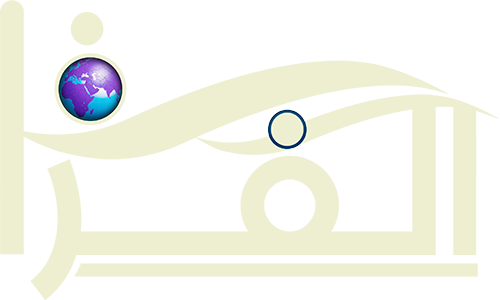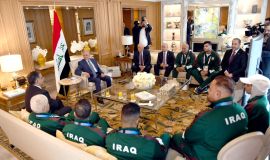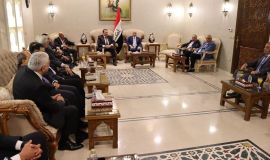-
رئيس الجمهورية يلتقي ماكرون ويؤكد على تعزيز العلاقات بين البلدين
-
وزير الداخلية يوجه بتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين بقضايا المخدرات
-
مديرية الاستخبارات تطيح بإرهابي خطير وتاجر مخدرات في بغداد
-
مكافحة الإرهاب يكشف إستراتيجيته بملاحقة تجار المخدرات ويحصي المقبوض عليهم
-
وزير النفط يفتتح إنجاز مشروع المرحلة الأولى لمحطة المعالجة المركزية في حقل الفيحاء
-
الفياض: نينوى ستبقى منيعة على الإرهاب ولا توجد أي خطورة حالياً
-
الإطاحة بتسعة دواعش في 4 محافظات
-
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية مشاركة الفرق والمنتخبات العراقية في المحافل الدولية
-
القبض على متهم بقتل عائلته في النجف الأشرف
-
السفارة العراقية تفتح آفاق التعاون مع رجال أعمال ومستثمرين مصريين للعمل في العراق
-
الرباع علي عمار سيرفع العلم العراقي في حفل افتتاح أولمبياد باريس
-
الفياض يتفقد قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي في منطقة الحضر
الاسلاميون واغراءات امام المنصب السياسي
مع صعود الاسلاميين الى الحكم في عدد من الدول العربية، تطرح اسئلة عديدة حول مستلزمات التحول 'من المعارضة الى الحكم' او
مع صعود الاسلاميين الى الحكم في عدد من الدول العربية، تطرح اسئلة عديدة حول مستلزمات التحول 'من المعارضة الى الحكم' او من 'الثورة الى الدولة' وما اذا كانت القيم والمبادئ التي نشأت عليها اجيال الصحوة الاسلامية ستجد طريقها الى التطبيق ام ستبقى جانبا من الثقافة التربوية المنفصلة عن الواقع.ويمكن القول ان هذا السجال سيفرض نفسه على الساحتين الفكرية والسياسية في المستقبل من الايام، خصوصا مع سعي القوى المناوئة للاسلاميين لتأكيد الثغرات في مشاريعهم السياسية والنهضوية. وستكون تجربة الاسلاميين في الحكم خاضعة لفحص دقيق من قبل مناوئيهم، خصوصا خارج الحدود، من اعداء المشروع الاسلامي والقوى الغربية الساعية لاستيضاح معالم هذا المشروع الذي ما يزال غامضا في ابعاده ذات الصلة بالقضايا الكبرى، خصوصا قضية فلسطين واستقلال القرار والتعددية والعلاقات مع الغرب. وستظل القضايا الاخرى التي تطرح من قبل الغربيين هامشية وان كانت الاضواء تسلط عليها اكثر من غيرها. فقضايا المرأة وحقوقها تحظى باهتمام كبير ولكنها ليست ذات شأن لدى القوى الكبرى بزعامة امريكا. بمعنى ان طرح هذه القضايا ليس لذاتها بل كوسائل للضغط في قضايا اخرى. فالحريات العامة ليست هي ما يدفع الغربيين للاهتمام بالاوضاع السياسية وتطوراتها في العالم العربي، بل ان العلاقات الخارجية والمواقف ازاء الغربيين وازاء 'اسرائيل' والسياسات الاقتصادية هي التي تحدد مواقفهم من التغيير المنشود في الدول العربية. ولمناقشة هذه القضايا التي تمثل في جوهرها 'هوية الحكم' يجدر طرحها من زوايا ثلاث: اولاها الهوية الثقافية للمشروع السياسي التغييري، ثانيتها: السياسات الخارجية المتصلة بالمصالح الغربية، ثالثتها: سجال الاخلاق والقيم والمبادىء ومدى واقعيتها في عالم السياسة الذي يوحي اللاعبون الاساسيون فيه بانه موصد بوجه من لا يلتزم بقيمه السائدة منذ عقود.
على مستوى الهوية الثقافية ما يزال عالم السياسة ناديا مغلقا على ذوي النفوذ المستمد من الامكانات العسكرية والاقتصادية التي تكرس الهيمنة السياسية لهذه القوى على العالم. وقد صيغت 'بروتوكولات' السياسة وفق هوى المنتصرين في الحروب، فهم الذين وضعوا مواثيق جنيف التي تنظم مفاهيم 'العلاقات الدولية' و'الحصانة الدبلوماسية' ومفاهيم 'الدولة القطرية' و'حقوق الانسان'. فالهوية الثقافية تنطوي على علمنة العلاقة بين الفرد بالدولة، وفصل الدين عن السياسة. ولكن الاخطر في هذه الهوية تكريسها مبدأ استعلاء الدول الخمس ذات النفوذ الاقوى عند انتهاء الحرب العالمية الثانية ومنحها امتيازات خاصة لا تعطى للدول الاخرى. فهذه الدول تمتلك حق النقض 'الفيتو' الذي يمنحها القدرة على افشال اي مشروع دولي يقره مجلس الامن اذا كان لا يتناسب مع سياساتها. كما يمنحها حق التسلح النووي المطلق. ان نظاما يقوم على منح مجموعة صغيرة من الدول امتيازات خاصة يعمق قيم التمييز والمحاباة ويسلب منه اهم قيمة انسانية متمثلة بالعدالة والمساواة بين البشر. ونجم عن ذلك تقسيم العالم الى عوالم ثلاثة، اضعفها العالم الثالث الذي يضم غالبية شعوب القارات الثلاث: آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية. ان هوية ثقافية تقوم على اساس الاستعلاء والتمييز تمثل تحديا للقوى السياسية الصاعدة في العالم الثالث، ويجب ان تشغل بال الانظمة السياسية ذات المنطلقات الايديولوجية والدينية التي يفترض ان تمنع التمايز او التفاضل بسبب مستوى القوة او الضعف لدى الدول والشعوب.
والملاحظ ان هذه الخصائص مكنت هذه الدول من تجاوز كافة الحدود والمعايير نظرا لشعورها بالحصانة، فهي المخولة باصدار قرارات الحرب والسلام، ووضع بروتوكولات التعامل الدولي في كافة المجالات، وتغليب قيم 'المنتصر' التي تفتقر لقيم العدل والمساواة والانصاف. الحكام الاسلاميون الجدد اصبحوا وجها لوجه مع هذه الهوية التي تؤثر عليهم بشكل مباشر اذا ما التزموا بمشروعهم الاسلامي ومستلزماته. فمصر تواجه استحقاقات فوز الاسلاميين الذين يواجهون تحديا خطيرا متمثلا بهيمنة 'اسرائيل' وسيادتها الامنية على جزيرة سيناء بسبب فرض تسوية 'المنتصر' على نظام يشعر نفسه مهزوما برغم تحقيقه بعض المكاسب العسكرية. ويواجه الرئيس المصري الدكتور مرسي تحديا تاريخيا بين ان يسعى لاستعادة الهوية الثقافية لمصر المؤسسة على السيادة والعدالة، وما يتطلبه ذلك من عمل حثيث لاصلاح النظام السياسي العالمي، او التخلي عن هوية المشروع السياسي الاسلامي، مؤكدا بذلك مقولة عدم ثبات المبادىء. ايران سعت لتحقيق هذا التغيير وواجهت مقاومة شرسة، واصبحت اليوم امام مفترق طريق خطير، بين الاصرار على تحقيق الهوية الثقافية لمشروع التغيير السياسي او الاستسلام للنظام الدولي الجائر. فلو تضافرت جهود مصر وايران وتركيا (وربما باكستان) لاستطاعت مجتمعة التأسيس لهوية ثقافية منسجمة مع قيم المشروع.
الجانب الثاني يتمثل بالعلاقات الخارجية التي تمثل، هي الاخرى، تحديا للمشروع السياسي الاسلامي، وتضع رموزه امام مستلزمات يتطلب تحقيقها المزيد من الجهد الفكري والتعب النفسي وربما التضحيات المادية. فاذا كانت الانظمة التي أسقطتها شعوب الثورات قد فشلت في تحديد معالم سياساتها الخارجية نظرا لافتقارها لمشروع تغييري، فان الاسلاميين مطالبون بتفعيل منظومة علاقات وتحالفات خارجية مؤسسة على مفاهيم الاسلام حول 'الامة الواحدة' و'الاخوة' و'العدل' و'إعمار الارض' و'التعاون على البر والتقوى'، بالاضافة للاستقلال وعدم التبعية او التنازل عن ثوابت الدين وقيمه امام الغرب. فمنذ عقودعاشت امة المسلمين مفككة بشكل افقدها قوتها وهيبتها، بعد ان تحولت من دولة الامة الى كيانات قطرية ضعيفة. وحيث ان ذلك التفكك حدث بفعل خارجي فقد تم التحكم في علاقات تلك الكيانات، ومنعت من التوحد مجددا، وابقيت الامة مهمشة فاقدة للمبادرة او المناعة الذاتية. ولم تؤد اقامة تحالفات اقليمية بين بعض هذه الدول الى وجود حقيقي وأثر فاعل لهذه الامة. فحلف بغداد الذي تأسس بمشاركة بريطانية مباشرة وتشجيع امريكي ضم كلا من العراق وباكستان وايران وتركيا لم يكن الهدف منه تقوية الامة بل التصدي للمد الشيوعي في ذروة الحرب الباردة. وبعد ثلاث سنوات من تأسيسه جاء عبد الكريم قاسم الى الحكم في العراق بانقلاب عسكري وقرر الانسحاب من الحلف فتم تغيير اسمه الى 'سنتو' اي منظمة المعاهدة المركزية. ولم يقم باي دور في المواجهة مع الكيان الاسرائيلي. وبعد الثورة الاسلامية في ايران تم حل هذا التحالف. وهناك الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وكلتاهما منظمتان ساهمتا قليلا في لم الشتات ولكن بمستوى متواضع جدا لا يرقى لما هو مطلوب لانهاض الامة والصعود بها الى مستوى التحدي. اليوم اصبح الاسلاميون (في مصر وتونس وتركيا وايران والمغرب والعراق) امام مستلزمات انهاض هذه الامة. وهذا جانب من مشروعهم الاسلامي الذي يتأسس على مفاهيم الدين والامة والانسان، بالاضافة للقيم الاخرى. فهل يستطيع هؤلاء القفز على محاولات التفتيت والتشتيت ورأب التصدعات والاختلافات المصطنعة في اغلبها، والتوافق ضمن مشروع نهضوي يتجاوز الحدود القطرية؟ أليس هذا من ثوابت مشروعهم الاسلامي الذي طالما روج لمفهوم 'الامة' واعتبر الحدود الجغرافية مصطنعة لا تنسجم مع مفهوم الامة الواحدة؟ لقد احتضن المشروع الاسلامي لدى اغلب الحركات قضية فلسطين واعتبرها القضية الاساس للامة، وانتقد تقاعس انظمة الاستبداد التي دعمها الغرب عن العمل من اجل تحرير الارض المغتصبة، فهل تحتل الآن مركزية لديهم؟ ام ستظل شعارات المعارضة مختلفة عن تطبيقات الحكم؟
ثالث السجالات يتمحور حول القيم والاخلاق والمبادىء، ومدى نجاح 'الاسلاميين' في الالتزام بها عندما يحكمون. وهنا تتوالى الصعوبات ويزداد الامتحان عسرا، فان خسر الاسلاميون الجماهير العريضة نتيجة التراجع عما روجوه من مبادىء وما تربوا عليه من قيم، فسوف يكون ذلك هزيمة نفسية وسياسية للمشروع. ولا يكفي التظاهر ببساطة العيش على المستوى الشخصي، وان كان ذلك مطلوبا، كما ليس المطلوب ان تذيل الخطابات وتنهى بالأيات القرآنية المباركة فحسب، بل ان يكون سلوكهم كأفراد وكمنظومة حاكمة منسجمة مع ما روجوا له. وهذه مشكلة لا يجوز التقليل من شأنها. وثمة خشية بان يتم التخلي تدريجيا ليس عن الشعارات السياسية والايديولوجية فحسب بل حتى عن البعد الاخلاقي في الممارسة. وكان من اكبر ما وجه لبعض الساسة الاسلاميين في العراق تهم الفساد، وبغض النظر عن مدى صحة تلك الاتهامات بالمستوى الذي اثيرت به، فان اي خلل في الممارسة السياسية او استغلال المنصب في التعيينات الادارية والسياسية او منح العقود التجارية او البذخ في الانفاق او في الرواتب، كل ذلك لا ينسجم مع المنظومة الاخلاقية التي يتأسس عليها المشروع الاسلامي. فاذا حدث مثل ذلك فسيتعمق الانطباع بان الاسلاميين لا يختلفون عن غيرهم في الممارسة، وسوف تتأكد مقولة يجب على الاسلاميين ابطالها. فحوى هذه المقولة ان الحكم له احكامه ومنطقه وقوانينه التي تنطبق على الجميع بغض النظر عن الايديولوجيا والمنطلق الفكري او الديني. وبالتالي فالمطلوب من الشخص الذي يحتل موقعا في الحكم ان ينصاع لكل ذلك، بينما يعتقد الاسلاميون ان عليهم ان 'يطهروا' منصب الحكم من الممارسات التي لا تستقيم مع ما يحملونه من مبادىء وقيم واخلاق. وبالتالي فالشخص هو الذي يؤثر على الكرسي، ولا يتأثر به.فاذا استطاع الاسلاميون تقديم نمط من الاداء يختلف عما الفه المواطن العربي من تكبر وتغطرس وبذخ ومظاهر زائفة وكذب وخداع، فسوف يكونون قد انجزوا شيئا كبيرا، واعادوا ثقة المواطن العربي بامكان تقديم اداء حسن عندما يتولى الاسلاميون زمام الامور. ان اي فشل في الاداء السلطوي سواء على مستوى افراد الحكم ام منظومته، ستكون له انعكاسات سلبية ليس على الفئة الحاكمة فحسب، بل على المبدأ نفسه، وهذا خطأ كبير يسيء الى سمعة الاسلام نفسه.
بين المعارضة والحكم بون شاسع، وهو بون لا يختصر بالهتافات او الشعارات او التمنيات، بل بوجود منهج حازم للحكم، وضوابط صارمة لمنع الانحراف او الانزلاق عن السلوك القويم. فالمعارضون الاسلاميون الذين دخلوا السجون وتعرضوا للتعذيب وصمدوا امام تنكيل الانظمة بهم وتحدوا الحكومات الديكتاتورية بشجاعة واستبسال وثبات، ولم يساوموا على ثوابتهم، اصبحوا اليوم امام امتحانات كبيرة، لن يضمنوا نجاحهم فيها الا اذا عقدوا العزم على ذلك وروضوا انفسهم ودربوها بشجاعة واصرار. فاغراءات المنصب والمال والجاه عامل كبير يساعد على الانزلاق والسقوط امام المغريات. فقد ينجح الشخص في الصمود امام مباضع الجلادين ويصمد امام المعذبين في زنزانات التعذيب، ولكنه قد يضعف امام ما يوفره المنصب من اغراءات. من هنا فالمطلوب ان يكون هناك اصرار من قبل الاسلاميين على عدد من الامور: أولها: ممارسة تربية جديدة مختلفة عن التربية التي مارسوها في مرحلة الدعوة والتبليغ والنضال. هذه التربية تتطلب فقها جديدا يتمحورحول اداء الدور في منصب الحكم والادارة وتقوية المناعة ضد المغريات المادية والتحصين امام النزوات.
ثانيها: وضع ضوابط لاختيار الاشخاص المناسبين للمناصب والمهمات القيادية والادارية مع مراقبة اداء الاشخاص ونزعاتهم الشخصية واذواقهم ومدى نزوعهم نحو البذخ والظهور وحب الجاه والسلطان، ثالثها: انتهاج نظام محاسبة صارم يساعد على مراقبة الاشخاص ومحاسبتهم وضمان استقامة سلوكهم قبل التعيين وخلاله. رابعها: الزام المؤهلين للحكم والادارة بتوقيع 'ميثاق شرف المهنة' كواحد من الكوابح التي تمنعهم من الخروج عن السلوك المطلوب. والحديث هنا لا يقتصر على السلوك الشخصي بل يشمل سلوك المجموعة واداءها من جهة ونمط تعامل الافراد (كمسؤولين او وزراء) مع المواطنين من جهة اخرى، فلا يجوز الكذب او الوعود الزائفة اوالتعامل باستعلاء او التضليل. مطلوب من الاسلاميين ان يعوا ان مشروعهم السياسي يجب ان يكون مصداقا لما روجوه وما تربوا عليه في سنوات الاعداد، وان لا يتناقض مع المبادىء الاسلامية التي تنظم العلاقات الاجتماعية كما تنظم السلوك الشخصي. انها فترة عصيبة في تاريخ الامة، وسوف يكون نجاح الاسلاميين فيها او اخفاقهم مؤشرا لمستقبلها ومدى قدرتها على تحقيق الاهداف التي رسموها كخريطة طريق للوصول الى دولة العدل التي تحكم امة متكاملة ومتعاونة وملتزمة. هذا التحدي لن يكون اقل مما واجهه النشطاء وهم يواجهون سياط الجلادين ويقاسون المنافي ويتهمون بشتى الجرائم.
المنصب ليس هو الذي يحكم التصرفات والسياسات، بل ان المبدأ هو الذي يحددها، هذه هي القاعدة التي يجب ان تتمخض عن تجربة الاسلاميين في الحكم. فقد انتخبتهم الجماهير متوخية فيهم صواب المنطق وصدق الموقف والاداء المناسب، وسيكون صدق انتمائهم للمشروع الاسلامي محل فحص من خلال ادائهم على المستويين الشخصي والمهني. مطلوب من كوادر الحركات الاسلامية ادراك حجم التحدي الذي يواجه مشروعهم وان يستوعبوا المهمة التاريخية المنوطة بهم كرواد لمشروع ايديولوجي وديني وهم يتحركون وسط بحر يعج باعداء مشروعهم من جهة، ويتسم بقدر كبير من الرقابة في العصرالالكتروني الذي يزداد تطورا.
د. سعيد الشهابي
' كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن